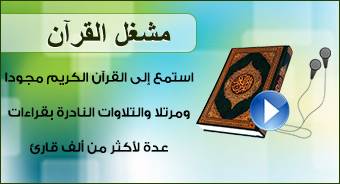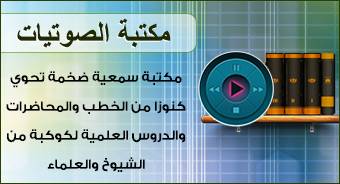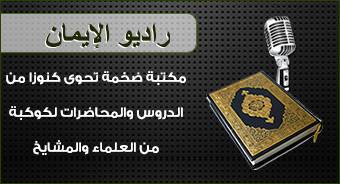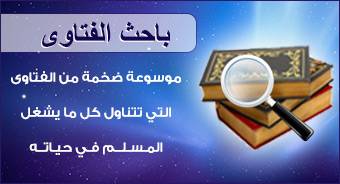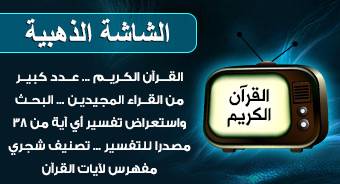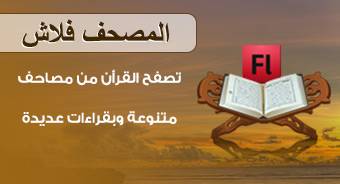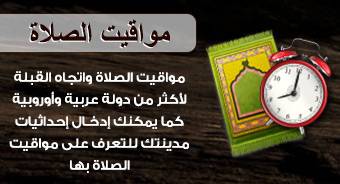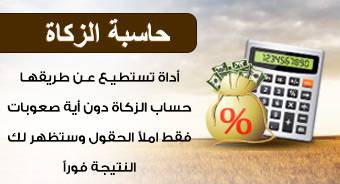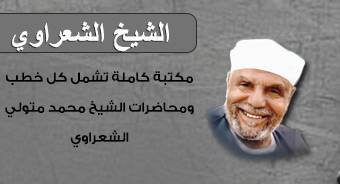|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
والجواب من أربعة أوجه:الأول: وهو اختيار ابن جرير ونقله عن رفيع بن العالية أن المعنى: إنّ الذين كفروا من اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد إيمانهم به قبل مبعثه ثم ازداوا كفرا بما أصابوا من الذنوب في كفرهم لن تقبل توبتهم من الذنوب التي أصابوها في كفرهم، ويدل على هذا الوجه قوله تعالى: {وأولئك هم الضالون}؛ لأنه يدل على أن توبتهم مع بقائهم على ارتكاب الضلال وعدم قبولها حينئذ ظاهر.الثاني: وهو أقربها عندي أن قوله تعالى: {لن تقبل توبتهم} يعني إذا تابوا عند حضور الموت، ويدل لهذا الوجه أمران:الأول: أنه تعالى بيّن في مواضع أخرى أنّ الكافر الذي لا تقبل توبته هو الذي يصر على الكفر حتى يحضره الموت في ذلك الوقت كقوله تعالى: {وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار}، فجعل التائب عند حضور الموت والميت على كفره سواء، وقوله تعالى: {فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا} الآية، وقوله في فرعون: {الآن وقد عصَيْتَ قبلُ وكنت من المفسدين}. فالإطلاق الذي في هذه الآية يقيّد بقيد تأخير التوبة إلى حضور الموت لوجوب حمل المطلق على المقيد كما تقرر في الأصول.الثاني: أنه تعالى أشار إلى ذلك بقوله: {ثم ازدادوا كفرا} فإنه يدل على عدم توبتهم في وقت نفعها، ونقل ابن جرير هذا الوجه الثاني- الذي هو التقيد بحضور الموت- عن الحسن وقتادة وعطاء الخراساني والسدي.الثالث: أن المعنى {لن تقبل توبتهم} أي إيمانهم الأول لبطلانه بالردة بعد، وهذا القول خرجه ابن جرير عن ابن جريج، ولا يخفى ضعف هذا القول وبعده عن ظاهر القرآن.الرابع: أن المراد بقوله: {لن تقبل توبتهم} أنهم لم يوفقوا للتوبة النصوح حتى تقبل منهم، ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: {إنّ الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكُنِ اللهُ ليغفر لهم ولا ليهدِيَهُم سبيلا}، فإنّ قوله تعالى: {ولا ليهديهم سبيلا} يدل على {إنّ الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم}، وكقوله: {إن الذين حقّت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون} الآية، ونظير الآية على هذا القول قوله تعالى: {فما تنفعهم شفاعة الشافعين} أي لا شفاعة لهم أصلا حتى تنفعهم، وقوله تعالى: {ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به} الآية؛ لأن الإله الآخر لا يمكن وجوده أصلا حتى يقوم عليه برهان أو لا يوم عليه.قال مقيده- عفا الله عنه-: مثل هذا الوجه الأخير هو المعروف عند النظار بقولهم: السالبة لا تقتضي وجود الموضوع وأيضاحه أن القضية السالبة عندهم صادقة في صورتين؛ لأن المقصود منها عدم اتصاف الموضوع بالمحمول، وعدم اتصافه به يتحقق في صورتين:الأولى: أن يكون الموضوع موجودا إلا أن المحمول منتف عنه، كقولك: ليس الإنسان بحجر فالإنسان موجود والحجرية منتفية عنه.والثانية: أن يكون الموضوع من أصله معدوما؛ لأنه إذا عدم تحقق عدم اتصافه بالمحمول الوجودي- لأن العدم لا يتصف بالوجود كقولك لا نظير لله يستحق العبادة- فإن الموضوع الذي هو نظير لله مستحيل من أصله، وإذا تحقق عدمه تحقق انتفاء اتصافه باستحقاق العبادة ضرورة. وهذا النوع من أساليب اللغة العربية، ومن شواهده قول امرؤ القيس:
لأن المعنى: على لا حب لا منار له أصلا حتى يهتدى به، وقول الآخر: لأنه يصف فلاة بأنها ليس فيها أرانب ولا ضباب حتى تفزع أهوالها أو ينجحر فيها الضب أي يدخل الجحر أو يتخذه. وقد أوضحت مسألة (أن السالبة لا تقتضي وجود الموضوع) في أرجوزتي في المنطق، في مبحث (انحراف السور)، وأوضحت فيها أيضا في مبحث (التحصيل والعدول) أن من الموجبات ما لا يقتضي وجود الموضوع نحو: (بحر من زئبق) ممكن والمستحيل معدوم؛ فإنها موجبتان، وموضوع كل منهما معدوم. وحررنا هناك التفصيل فيما يقتضي وجود الموضوع وما لا يقتضيه.وهذا الذي قررنا من أن المرتد إذا تاب قبلت توبته ولو بعد تكرر الردة ثلاث مرات أو أكثر، لا منافاة بينه وبين ما قاله جماعة من العلماء من الأربعة وغيرهم، وهو مروي عن علي وبن عباس رضي الله عنهما من أن المرتد إذا تكرر منه ذلك يقتل ولا تقبل توبته، واستدل بعضهم على ذلك بهذه الآية؛ لأن هذا الخلاف في تحقيق المناط لا في نفس المناط، والمتناظران قد يختلفان في تحقيق المناط مع اتفاقهما على أصل المناط، وأيضاحه أن المناط مكان النوط وهو التعليق، ومنه قول حسان رضي الله عنه: والمراد به: مكان تعليق الحكم وهو العلة، فالمناط والعلة مترادفان اصطلاحا، إلا أنه غلب التعبير بلفظ المناط في المسلك الخامس من مسالك العلة الذي هو المناسبة والإخالة؛ فإنه يسمى تخريج المناط، وكذلك في المسك التاسع الذي هو تنقيح المناط، فتخريج المناط: هو استخراج العلة بمسلك المناسبة والاخالة، وتنقيح المناط: هو تصفية العلة وتهذيبها حتى لا يخرج شيء غير صالح لها، ولا يدخل شيء غير صالح لها كما هو معلوم في محله، وأما تحقيق المناط- وهو الغرض هنا- فهو: أن يكون مناط الحكم متفق عليه بين الخصمين، إلا أن أحدهما يقول: هو موجود في هذا الفرع، والثاني: يقول: لا، ومثاله: الاختلاف في قطع النباش؛ فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يوافق الجمهور على أن السرقة مناط القطع، ولكنه يقول: لم يتحقق المناط في النباش؛ لأنه غير سارق، بل هو آخذ مال عارض للضياع كالملتقط من غير حرز.فإذا حققت ذلك، فاعلم أن مراد القائلين: لا تقبل توبته أن أفعاله دالة على خبث نيته وفساد عقيدته، وأنه ليس تائبا في الباطن توبة نصوح، فهم موافقون على أن التوبة النصوح مناط القبول كما ذكرنا، ولكن يقولون: أفعال هذا الخبيث دلّت على عدم تحقيق المناط فيه، ومن هنا اختلفت العلماء في توبة الزنديق المستتر بالكفر، فمن قائل: لا تقبل توبته، ومن قائل: تقبل، ومن مفرق بين إتيانه تائبا قبل الإطلاع عليه وبين الإطلاع على نفاقه قبل التوبة، كما هو معروف في فروع المذاهب الأربعة؛ لأن الذين يقولون: يقتل ولا تقبل توبته يرون أن نفاقه الباطن دليل على أن توبته تقية لا حقيقة، واستدلوا بقوله تعالى: {إلا الذين تابوا وأصلحوا}، فقالوا: الإصلاح شرط والزنديق لا يُطَّلَعُ على إصلاحه؛ لأن الفساد أتى مما أسرَّهُ، فإذا اطلع عليه وأظهر الإقلاع لم يزل في الباطن على ما كان عليه.والذي يظهر أن أدلة القائلين بقبول توبته مطلقا أظهر وأقوى كقوله صلى الله عليه وسلم لأسامة رضي الله عنه: «هلاّ شققت على قلبه»، وقوله للذي ساره في قتل رجل قال: «أليس يصلي؟» قال: بلى، قال: «أولئك الذين نهيت عن قتلهم»، وقوله- لخالد لما استأذنه في قتل الذي أنكر القسمة-: «إني لم أؤمر أن أنقِّبَ عن قلوب الناس»، وهذه الأحاديث في الصحيح، ويدل لذلك أيضا: إجماعهم على أن أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر، وقد نصّ تعالى على أن الإيمان الكاذبة جُنّةٌ للمنافقين في الأحكام الدنيوية بقوله: {اتخذوا أيمانهم جنة}، وقوله: {سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتُعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم فإنهم رجس}، وقوله: {ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم} الآية، إلى غير ذلك من الآيات.وما استدل به بعضهم من قتل ابن مسعود لابن النواحة صاحب مسيلمة، فيجاب عنه: بأنه قتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم- حين جاءه رسولا لمسيلمة-: «لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك»، فقتله ابن مسعود تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم، فقد روي أنه قتله لذلك، فإن قيل: إن هذه الآية الدالة على عدم قبول توبتهم أخص من غيرها؛ لأن فيها القيد بالردة وازدياد الكفر، فالذي تكررت منه الردة أخص من مطلق المرتد، والدليل على الأعم ليس دليلا على الأخص؛ لأن وجود الأعم لا يلزم وجود الأخص، فالجواب: أن القرآن دل على توبة من تكرر منه الكفر إذا أخلص في الإنابة إلى الله، ووجه الدلالة على ذلك قوله تعالى: {إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا}، ثم بيّن أن المنافقين داخلون فيهم بقوله تعالى: {بشِّر المنافقين بأنّ لهم عذابا أليما} الآية، ودلالة الاقتران وإن ضعفها بعض الأصوليين فقد صححتها جماعة من المحققين، ولاسيما إذا اعتضدت بدلالة القرينة عليها كما هنا؛ لأن قوله تعالى: {لم يكنِ الله ليغفرَ لهم ولا ليهديَهم سبيلا بشّر المنافقين بأن لهم عذابا أليما} فيه الدلالة الواضحة على دخولهم في المراد بالآية، بل كونها في خصوصهم قال به جماعة من العلماء.فإذا حققت ذلك فاعلم أن الله تعالى نصّ على أن من أخلص التوبة من المنافقين تاب الله عليه بقوله: {إنّ المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرًا عليما}، وقد كان مخشي بن حمير رضي الله عنه من المنافقين الذين أنزل الله فيهم قوله تعالى: {ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم} فتاب إلى الله بإخلاص، فتاب الله عليه، وأنزل الله فيه: {إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة} الآية، فتحصّل أن القائلين بعدم قبول توبة من تكررت منه الردة يعنون الأحكام الدنيوية ولا يخالفون في أنه أخلص التوبة إلى الله قبلها منه؛ لأن اختلافهم في تحقيق المناط كما تقدم، والعلم عند الله تعالى. اهـ.
|